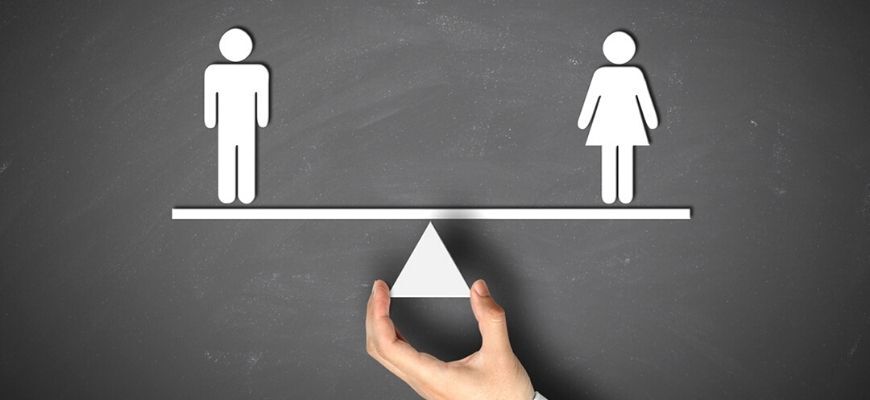المرأة المغربية: الحداثة والمساواة
ذ إدريس بنيحيى
I-المسألة النسائية بالمغرب: أية مقاربة منهجية؟
تعترض الدارس لواقع النساء بالمغرب الراهن عدة صعوبات منهجية ترتبط في مجملها بالتساؤل عن أنجح المقاربات العلمية والنظرية لتناول هذه القضية، وتزداد هذه الصعوبة تعقيدا بالنظر إلى أن جل الكتابات حول النساء طيلة عقود الاستقلال لم تكن وليدة تراكم تقاليد جامعية، بل تمت على هامش الجامعة المغربية من طرف الجمعيات النسائية والوزارات المعنية والمنظمات الدولية وهي كتابات تتقاسمها مقاربتان متعارضتان تنطلق الأولى من حصر كل قضايا المرأة المغربية داخل فضاء المقدس بكل حمولته الدينية والفقهية الإسلامية والسياسية حيث ترى هذه المقاربة أن إعادة إحياء الموروث الفقهي الإسلامي كما صاغه السلف ،كاف لوحده في نظرها لتكريم المرأة المغربية باعتبارها امرأة مسلمة لا كمواطنة، في مجتمع مسلم. في مقابل هذه المقاربة المتعالية على التاريخ تنتصب مقاربة أخرى هي مقاربة العلوم الاجتماعية أي علوم التاريخ والسيسيولوجيا والأنثروبولوجيا وعلم السياسة والاقتصاد والقانون…… والتي توفر للباحث الأدوات المنهجية الملائمة لفهم الإشكالية النسائية بالمغرب في أبعادها المختلفة لا يمثل فيها البعد الديني إلا عنصرا واحدا ضمن عدة عناصر أخرى. أما الصعوبة الثانية فتتصل بالتساؤل التالي:
هل يمكن اعتبار النساء فئة اجتماعية فقط لأنهن يقتسمن الشرط النسوي ويخضعن لنفس القوانين ونفس السلطة الذكورية؟ أعتقد أن الحديث عن النساء كفئة اجتماعية متجانسة فيه اختزال شديد لتعقد الواقع الاجتماعي في شعار سياسي يريد تغيير الواقع دون أن يفهمه كما تقول رحمة بورقية «أعتقد أن المرأة المنتمية للطبقة البورجوازية تعيش السلطة الذكورية بصورة مغايرة عن المرأة التي تنتمي إلى طبقة اجتماعية كادحة”
إن الخطاب النسائي كخطاب سياسي يعطي لفئة النساء وحودا نظريا لا يوجد بالضرورة في الواقع. ومع ذلك فإنه يجب التنويه بالدور التاريخي لنساء الفئات الوسطى المتعلمات ليس فقط في إنتاج الخطاب النسائي بل أيضا في الكشف عن أطر الاستغلال الذكوري والجنسي وسبل مقاومته. “فالنسائية-تقول رحمة بورقية-لم تكن وليدة عمل النساء اللواتي يمارس عليهن الخضوع ويعانين من ظروف صعبة في حياتهن، بل تمت على يد النساء اللواتي يتحركن باسم الأخريات لنقل اهتماما تهن الثقافية من الهامش إلى المركز وبالتالي جعلهن يحظين بمكانة في الحياة العمومية والسياسية”
II-الواقع النسائي تكثيف لشبكة من العلاقات السلطوية :
أثمر النقاش النظري حول المسألة النسائية بالغرب منذ الستينيات بروز مقاربتان متباينتين: الفردانية من جهة ،والعلائقية من جهة أخرى. تستعير المقاربة الأولى الفلسفة الفردانية والليبرالية حيث تعتبر أن للمرأة باعتبارها فردا مستقلا في المجتمع، حقوقا فردية مدنية وسياسية على غرار الرحل. أما المقاربة العلائقية، فهي في الوقت الذي تؤكد فيه على أهمية النوع والمساواة داخل الأسرة والمجتمع، فهي تضع النساء ضمن شبكة العلاقات التي تربطهم بالذكور والمجتمع في آن واحد. وإذا كان من الجائز الحديث في المغرب الحالي عن وجود نزعات فردانية طوعية ما فتئت تتسع في بعض أوساط النساء المتعلمات من الفئات الوسطى بالمدن الكبرى والمتوسطة في استقلال شبه تام عن سلطة الأسرة والرجل مما يؤشر في نظري على بداية تجاوز لفكر الانتماء للجماعة. ( (l’esprit communautaireباعتباره فكرا ما قبل حداثي، فإن الطابع الغالب على واقع النساء المغربيات هو واقع العلاقات السلطوية والتراتبية بين الجنسين.
من هنا، فان المقاربة العلائقية للسلطة بمعناها الواسع هي التي توجه سلوك سلوك الحركة الحركة النسائية المغربية منذ أواسط الثمانينيات، فالمطالب التي بلورتها مثلا حول مدونة الأسرة تتجاوز إشكالية العلاقة بين الزوجين لتطال المجتمع برمته وحاجته إلى التقدم، وتعكس علاقة المرأة بالرجل شبكات السلطة التي تخترق المجتمع كله إذ ليس هناك وجود اجتماعي للمرأة إلا في علاقتها بالرجل وهي علاقة تنبني على تراتبية تخضع بموجبها النساء للرجال. وليس هناك وجود قبلي للسلطة الذكورية، بل هي وليدة آليات اجتماعية تنتج باستمرار قيم الخضوع التي يعطيها المجتمع المبررات الشرعية الضرورية فالمرأة مثلا تقبل سلطة الزوج لان سلطة هذا الأخير تكتسب شرعيتها من كونه هو المسؤول عن الموارد المالية للأسرة، والمرأة وهي تقبل سلطته أيضا لأن القانون يجعله وصيا على الأسرة وعلى الثقافة التي تنتج إجماعا حول شرعيتها. وتساهم وسائل التنشئة الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة في تحديد دور الجنسين في المجتمع، كما تقوم المرأة نفسها بدور أساسي في إنتاج وإعادة إنتاج السلطة الذكورية من خلال عملية تلقين بناتها قيم الامتثال للقواعد الاجتماعية والطقوس البالية الموروثة ولتوضيح دور التنشئة الاجتماعية في ترسيخ الذهنية التقليدية، أسوق المثالين التاليين: الأول يتعلق بفضاء المطبخ الذي مازال فضاء أنثويا بامتياز بسبب مقاومة الرجل والمرأة نفسها لدخول هذا الأخير إلى هذا الفضاء الذي تستمد منه شيئا من السلطة، بينما يسمح للذكور بالانفتاح منذ وقت مبكر على العالم الخارجي. المثال الثاني يتصل بموضوع الجنس الذي لا يزال يندرج في عداد الطابوهات التي يحاط النقاش فيها بكثير من التكتم والحذر مما يجعل جل الشباب المغربي يكتسب “معارفه” الأولية حول الجنس من فضاءات خارجية غير مؤسسية في غياب تربية جنسية بالمؤسسات التعليمية والجامعات القادرة وحدها على تزويد الشباب بالمعرفة العلمية الصحيحة حول الجنس كنشاط بشري غريزي ضروري لتوازن المجتمعات وكآلية للتناسل والتكاثر بصرف النظر عن القيم الأخلاقية والثقافية التي تؤطره في مجتمع معين ،وإذا كان المجتمع المغربي يتعامل بكثير من المرونة والتسامح مع التجارب الجنسية للذكور باعتبارها تمرينا ضروريا ومرغوب فيه قبل الدخول إلى مؤسسة الزواج، فإنه بالمقابل يخضع على العموم جنسية الفتاة لرقابة شديدة.
وإذا كان صحيحا كذلك أن كثيرا من الفتيات يحرصن على نسج علاقة عاطفية مع صديق ينظرن إليه كزوج محتمل ويقمن في نفس الوقت بإقامة علاقة جنسية مع رجل أو رجال آخرین بعيدا عن مراقبة الأسرة مقابل مكاسب مادية أو اجتماعية كما أثبتت ذلك السوسيولوجية سمية نعمان جسوس في دراستها حول 200 امرأة بالدار البيضاء خلال الثمانينات، فان هذا الشذوذ الجنسي غير الواعي لا يعد و أن يكون تعبيرا عن انتقام من نظام اجتماعي ما فتئ يجثم بثقله على المرأة ويختزلها في حسم وموضوع للجنس.
وعلى الرغم من المكانة المقدسة التي لا يزال يحتفظ بها الزواج في المجتمع المغربي، فإن غياب المساواة بين الجنسين يجعل العلاقات الزوجية لا تلبي حاجة إنسانية واجتماعية للمرأة والرجل معا بل تأتي استجابة لحاجيات الخارج أي لحاجيات المجتمع الذي يعتبر الزواج هدفا في حد ذاته وليس وسيلة للانفتاح والرقي بحياة الزوجين على المستويين الإنساني والاجتماعي. إن التجلي الاجتماعي للزواج أي إنجاب الأطفال هو أكثر أهمية من الزواج في حد ذاته؟.
III -المسألة النسائية بالمغرب وثقافة الرمز:
تحتاج المسألة النسائية في علاقتها بالثقافة الذكورية إلى مقاربتها من زاوية العلاقات الاجتماعية بما تنطوي عليه من سلطة، لكنها تحتاج أيضا الكشف على الثقافة التي تعطيها أبعادا رمزية في مجتمع معين. إن الثقافة في معناها الأنطروبولوجي تمارس سلطتها على سلوك الأشخاص تحت تأثیر عوامل واعية ولا واعية متعددة، فهي تخلق القيم والرموز التي تجعل مجتمعا يختلف عن مجتمع آخر. الثقافة بهذا المعنى تخلق الإحساس بالهوية وبالانتماء إلى أنا جماعية، بل إن الثقافة كما تقول رحمة بورقية لا تفتن بعلماء الأنطر وبولوجيا فحسب بل أيضا بمن يستهلكها أي بالجماعة التي يقتسم أفرادها نفس التجارب ونفس المتخيل ويتسرب فعلها الخفي و المؤثر بصورة غير مباشرة في نفوس الأشخاص عن طريق اللباس والأكل والأقوال المأثورة والصور والطقوس الاحتفالية……. وهناك أمثلة لا حصر لها في المجتمع المغربي تتخذ فيها الثقافة أبعادا رمزية كبيرة أكتفي هنا بذكر مثالين.
يتصل الأول بطقوس الولادة والثاني بالزواج. في المثال الأول يحدد جنس المولود مباشرة بعد ميلاده نوعية ردود الفعل التي تلي ولادته فهناك عرف متبع في الأوساط القروية والحضرية يقضي بإطلاق النساء لعدد من الزغاريد تعبيرا عن سعادة الأسرة وذلك أثناء إنجاب المرأة بالمنزل، لكن عدد الزغاريد يختلف حسب نوع جنس المولود، ففي حالة الذكر تطلق النساء ثلاث زغاريد بينما لا يتجاوز عددها زغرودة واحدة في حالة الأنثى، بل إن بعض المناطق تستقبل الأنثى بصمت تام. إذن منذ اللحظة الأولى للولادة تتسرب ثقافة التمييز تبعا لنوع الجنس. يعتبر هذا المنظور أن الذكر يملأ المنزل بينما تفرغه الأنثى لأن اسم الذكر سيظل مرتبطا بشجرة الأسرة بينما ستتخلى عنه الأنثى لفائدة أسرةأخرى. إن الذكر هو تعبير عن الامتلاء والإشباع بينما تعبر الأنثى عن الإفراغ.
أما المثال الثاني فيتصل بطقوس الزواج الذي تتقاطعه ازدواجية السلبية من جهة، والحيوية من جهة أخرى، إذ في الوقت الذي تشل فيه حركة الفتاة/ العروس، فإن الزوج/ العريس يكون حرا في تحركاته، فهو الذي يعطي صداقا لزوجته ويهديها الهدايا ويمول الزواج ويتجه إلى منزل أصهاره ليأخذ زوجته إلى بيتها الجديد، بينما تسلم هذه الأخيرة جسدها كليا لسيدات قصد تزیینه وإلباسه في ظل سلبية تامة تجاه ما يحيط بها،بل عليها أن تستجيب عن طواعية لكل ما تطلبنه منها. وتعطي تسمية مولاي السلطان الذي يحيط به مجموعة من الوزراء بعدا رمزيا أكبر للتراتبية التي تميز علاقة العروسين، إن استعارة اللقب السلطاني الممزوج بالشرف بما يوحي إليه من فض البكارة وإشهار ذلك على العموم، تعني أن طقوس الزواج تهيئ الزوج على المستوى الرمزي لحكم ملكيته